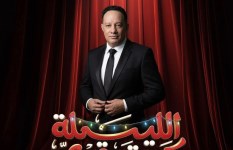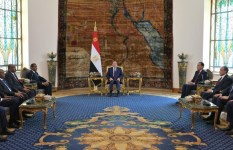خطبة الجمعة القادمة لوزارة الأوقاف 21 نوفمبر 2025م ـ 30 جمادى الأولى 1447هـ
الأحد، 16 نوفمبر 2025 04:14 م
السيد الطنطاوي

وزارة الأوقاف
حدَّدت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة بتاريخ 21 من نوفمبر 2025م، الموافق 30 من جمادى الأولى 1447هـ، وستكون الخطبة الأولى بعنوان "كُن جَميلاً تَرَ الوُجودَ جَميلا"، والخطبة الثانية بعنوان “التعدي على الجار” ضمن مبادرة “صحح مفاهيمك”.
وذكرت وزارة الأوقاف، أن الهدف من الخطبة الأولى "كُن جَميلاً تَرَ الوُجودَ جَميلا "، هو التوعية التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر، وأما الخطبة الثانية “التعدي على الجار”، فتسلط الضوء على أهمية احترام الجار وحقوقه، وتصحيح السلوكيات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التعدي عليه، من خلال خطاب دعوي وتوعوي يركز على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية.
خطبة الجمعة القادمة 14 نوفمبر 2025م لوزارة الأوقاف: كُن جَميلاً تَرَ الوُجودَ جَميلا، بتاريخ 30 جمادي الأولي 1447 هـ ، الموافق 21 نوفمبر 2025م.
نص الخطبة الأولى
كُن جَميلاً تَرَ الوُجودَ جَميلا
الحمد لله رب العالمين، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أما بعد:
فمما يُفيضه الإيمان على أهله، الارتقاء بمعاني الأخلاق، وإكمال دائرة القيم، حتى يكونوا أنموذجًا لِتَجَسُّد المعاني الإيمانية في النفس البشرية، تلك النفوس التي طهَّرها اليقينُ من كدَر الهوى، وزكَّاها الصدق في مراقبة الله تعالى عن الرَّدى، حتى سمت أفعالها، ورقَّت كلماتُها، وشفَّت طباعُها، فصارت وكأنَّها مَرايا تعكس ما استقرَّ في أعماقهم من نور الهداية، فإذا مشَوا في الناس، مشَوا بالطمأنينة والسكينة، وإذا تعاملوا، تعاملوا بالرأفة والرحمة، حتى يخيَّل للرائي أنَّه يشهد كيف يتحوَّل الإيمان إذا استقرَّ في القلب، إلى خُلُقٍ يمشي على الأرض، ونورٍ يتشكَّل في الأفعال.
ومن جملة المعاني الإيمانية التي حرص الإيمان على إكمالها وإتمامها في أهله وذويه؛ قيمة الجمال والأدب والذوق والرقي في التعامل مع الغير، سواء حال الوفاق أو الاختلاف، فأهل الإيمان لا يصدر عنهم إلا كلُّ جميل قولًا وفعلًا وحالًا، وكي يقيمَنا الشرع الحنيف على هذه المعاني والقيم أرشدنا إلى عدة أمور، منها:
إن الله جميل يحب الجمال:
قاعدة نبوية يلفت فيها أنظارَنا نبيُّنا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى وصف مولانا تبارك وتعالى بالجمال، ومحبته لهذه القيمة، فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ»، قَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ، الْكِبْرُ بطر الحق وغمط الناس» [رواه مسلم]
وما لفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلا ليسري هذا المعنى فينا، وليحثَّنا على التزامه، حتى تحصل لنا المحبة الربانية والمعيَّة الإلهيَّة في جميع أحوالنا.
ومن أسف أننا نقصر معنى الحديث النبوي على خصوص السبب الذي ورد فيه، فنحمله على جمال الملبس والمظهر فحسب، وما هكذا ذكر العلماء، بل توسعوا في بيان مفهوم وصف الله تعالى بالجمال، ومحبته سبحانه منا هذا الوصف، يقول أبوبكر الكلاباذي الحنفي في شرح هذا الحديث: "وَقَولُهُ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ» أَي: جَمِيلُ الأَفضَالِ بِكُم، حَسَنُ النَّظَرِ لَكُم، مُرِيدٌ لِصَلَاحِكُم، جَمِيلُ المُعَامَلَةِ مَعَكُم، يَرضَى بِالقَلِيلِ، وَيُثِيبُ عَلَيهِ الجَزِيلَ، وَيَقبَلُ الحَسَنَاتِ المَدخُولَ عَلَيهَا، وَيَعفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ المَسكُونِ إِلَيهَا، يُكَلِّفُكُمُ اليَسِيرَ وَيُعِينُكُم عَلَيهِ، وَيُعطِيكُمُ الجَزِيلَ وَيَشكُرُكُم عَلَيهِ وَلَا يَمُنُّ عَلَيكُم، وَتَعطُونَ القَلِيلَ وَيَشكُرُكُم، فَهُوَ يُحِبُّ الجَمَالَ مِنكُم أَيِ: التَّجَمُّلَ مِنكُم فِي قِلَّةِ إِظهَارِ الحَاجَةِ إِلَى غَيرِهِ، فَإِنَّهُ قَامَ لَكُم بِهَا، وَمَا زَوَى عَنكُم، زَوَاهَا نَظَرًا لَكُم، وَإِرَادَةَ الخَيرِ بِكُم، فَتَجَمَّلُوا فِيمَا بَينَكُم، وَلَا تَشكُوهُ إِلَى غَيرِهِ بِإِظهَارِ حَوَائِجِكُم، فَهُوَ جَمِيلُ الفِعلِ بَينَكُم، يُحِبُّ التَّجَمُّلَ مِنكُم". [بحر الفوائد]
ويقول المناوي: "«إن الله تعالى جميل» له الجمال المطلق، ومن أحق بالجمال منه، كل جمال في الوجود من آثار صنعته، فله جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال، ولولا حجاب النور على وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه من خلقه «يحب الجمال» أي: التجمل منكم في الهيئة، أو في قلة إظهار الحاجة لغيره، وسر ذلك أنه كامل في أسمائه وصفاته، فله الكمال المطلق من كل وجه، ويحب أسماءه وصفاته، ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإنه من لوازم كماله". [فيض القدير]
الجمال في البيان القرآني:
إنَّ المتتبِّع لآياتِ القرآن التي نطقت بوصفِ الجَمال ليَجِد مشهدًا يثير الدهشة ويستوقف البصيرة؛ إذ يربط اللهُ تعالى هذا الوصفَ الرفيع بأحوالٍ يغلِبُ فيها الاضطرابُ على النفوس، كالصبر والهجر والصفح، وهي مواطنُ تنساق فيها الطباعُ وراء حدَّة الانفعال وثورة المشاعر، فإذا بالوحي يخصّها بصفة الجمال، ليُعلِّم القلبَ أن السموَّ الأخلاقي لا يُختبر في لحظاتِ الرخاء، بل في مواضِع الضِّيق، وأنَّ الجمال ليس حليةً فحسب، بل هو مقامٌ روحيٌّ يضبط الانفعال، ويهذِّب الردَّ، ويرفعُ الإنسانَ فوقَ غوائلِ النَّفس ودسائسها.
يقول المجد الفيروزآبادي: "وقد ورد في القرآن هذه المادّة -مادة الجمال- على وجوه:... بمعنى المحاسنة والمجاملة {فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} [الحجر: ٨٥]، وبمعنى الصَّبر بلا جزاء {فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا} [المعارج: ٥]، وقال يعقوب عليه السلام {فَصَبْرٌ جَمِيل} [يوسف: ١٨]، وبمعنى مقاطعة الكفَّار على الوجه الحسن {وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا} [المزمل: ١٠]، وبمعنى إِطلاق النِّساءِ على الوجه الجميل {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: ٤٩]. [بصائر ذوي التمييز]
ولا شك أن تقييد هذه الأوامر بالجمال يقتضي جهدًا زائدًا، وتحمُّلًا أكبر وأوسع من العادي، ولن تتأتى هذه المعاني إلا ممن تجردت لله نيته، وعلَت همته، وتهذبت نفسه، وصدق حاله.
التعارف شعار الإسلام:
من سنن الله تعالى في خلقه وحكمته أن جعلهم متفاوتين في لغتهم وألوانِهم وطباعِهم وأفكارهم وعقولهم، وهذا الأمر من دلائل وحدانيته وقدرته، قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ} [الروم: ٢٢].
والحكمة في التفاوت التعارفُ والتكاملُ، لا التعارك والتقاتل، كما أنبأ عنه قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} [الحجرات: ١٣].
وجعلهم متفاوتين في الهداية، قال الله تعالى: {وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ} [هود: ١١٨، ١١٩].
فيخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة، من إيمان أو كفران، كما قال تعالى: {ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا} [يونس: ٩٩]، وقوله: { وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} أي: ولا يزال الخلف بين الناس في أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم، وقوله: {إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ} أي: إلا المرحومين من أتباع الرسل، الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين الذي أخبرتهم به رسل الله إليهم، ولم يزل ذلك دأبهم، حتى كان النبي الأمي صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل والأنبياء، فاتبعوه وصدقوه، ونصروه ووازروه، ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة [تفسير ابن كثير].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، وَالْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» [رواه مسلم].
وعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالحَزْنُ وَالخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ» [رواه أبو داود والترمذي، وأحمد].
الاختلاف .. أخلاقيات وآداب:
نتيجة لتفاوت الأفهام والعقول والمطامح والرغبات، قد يقع الخلاف بيننا، ومن هنا استنبط العلماء من الوحي الشريف القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، جملة من الأخلاقيات والآداب التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها في هذه الحال، لئلا يؤدي هذا الخلاف البسيط إلى تعصب وتنازع وسباب، وما إلى ذلك من أمور تتنافى وعظمة الإسلام، ومن جملة تلك الآداب:
• الإنصــــــــــــــــاف من النفس
قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} [النحل: ٩٠].
وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ} [المائدة: ٨].
أي: لا يحملنكم الخلاف والعداوة التي بينكم وبين غيركم على ألا تعدلوا.
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [النساء: ١٣٥].
فقد تضمنت الآيتان الأمر بالتزام القسط والإنصاف، والنهيَ عن تركه وتنكبه، وذلك في أشد المواطن على النفس وأدعاها إلى الميل والتحيز، وهي عموما تتمثل في حالات الحب والبغض.
قال سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنهما: "ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصافُ من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار" [رواه البخاري].
وقال ابن حجر بعد ما خرَّج هذا الأثر: "قال أبو الزناد ابن سِراج وغيره: إنما كان من جمع الثلاث مستكملاً للإيمان لأن مداره عليها، لأن العبد إذا اتصف بالإنصاف لم يترك لمولاه حقًّا واجبًا إلا أدّاه، ولم يترك شيئًا مما نهاه عنه إلا اجتنبه، وهذا يجمع أركان الإيمان، وبذل السلام: يتضمن مكارم الأخلاق والتواضع وعدم الاحتقار، ويحصل به التآلف والتحابب، والإنفاق من الإقتار: يتضمن غاية الكرم، لأنه إذا أنفق مع الاحتياج كان مع التوسع أكثر إنفاقًا، وكونه من الإقتار يستلزم الوثوق بالله، والزهد في الدنيا، وقصر الأمل، وغير ذلك من مهمات الآخرة". [فتح الباري]
وقال ابن عبد الهادي الحنبلي: "وما تحلى طالب العلم بشيء أحسن من الإنصاف".
وقال المعتصم الخليفة العباسي كلمته الحكيمة الرشيدة: "إذا نُصِر الهوى بَطَل الرأي" [تاريخ الطبري]، فنُصْرة الهوى تُفسِد الرأي السديد، والقول الرشيد.
وقال تعالى: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ} [الأعراف: ٨٥].
قال سعيد بن المسيب رحمه الله: "إنه ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، ومن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله" [صفة الصفوة].
وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ» [رواه أبو داود، وأحمد]. رَدْغَةَ الْخَبَالِ: عصارة أهل النار.
وعن الإمام الشافعي رحمه الله، قال: "وددت أن الناس انتفعوا بهذا العلم وما نسب إلىَّ شيء منه"، وقال: "ما ناظرت أحداً قط فأحببت أن يخطئ"، وقال: "ما كلمت أحدًا قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويعان، ويكون عليه رعاية من الله تعالى وحفظ، وما كلمت أحدًا قط وأنا أبالي أن يبين الله الحق على لساني أو على لسانه"، وقال: "ما أوردت الحق والحجة على أحد فقبلها مني إلا هبته واعتقدت محبته، ولا كابرني أحد على الحق ودافع الحجة إلا سقط من عيني ورفضته". [إحياء علوم الدين].
وقال رجل لابن مسعود رضي الله عنه: أوصني بكلماتٍ جوامع، فكان مما أوصاه به أن قال: "من أتاك بحق فاقبل منه وإن كان بعيدًا بغيضًا، ومن أتاك بالباطل فاردده وإن كان قريبًا حبيبًا" [الإحكام في أصول الأحكام].
• التماس الأعذار
عن سعيد بن المسيب رحمه الله، قال: "كتب إليَّ بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد له في الخير محملا" [شعب الإيمان].
وفي غزوة تبوك تأخر كعب بن مالك عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوة فسأل عنه قائلا: «ما فعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عِطفيه، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله: ما علمنا عليه إلا خيرا، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. [رواه مسلم].
وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ رحمه الله، قَالَ: "إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيكَ شَيْءٌ فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا، فَقُلْ: لَهُ عُذْرٌ" [شعب الإيمان].
عن جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ رحمه الله، قال: "إِذَا بَلَغَكَ عَنْ أَخِيكَ الشَّيْءُ تُنْكِرُهُ فَالْتَمِسْ لَهُ عُذْرًا وَاحِدًا إِلَى سَبْعِينَ عُذْرًا، فَإِنْ أَصَبْتَهُ وَإِلَّا قُلْ: لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا لَا أَعْرِفُهُ" [شعب الإيمان].
قال الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَيْهَقِيِّ رحمه الله:
قِيلَ لِي: قَدْ أَسَاءَ إِلَيْكَ فُلَانٌ ... وَمُقَامُ الْفَتَى عَلَى الذُّلِّ عَارُ
قُلْتُ: قَدْ جَاءَنَا فَأَحْدَثَ عُذْرًا ... دِيَةُ الذَّنْبِ الِاعْتِذَارُ
والمعنى: "الْمُؤْمِنُ يَطْلُبُ عُذْرَ إِخْوَانِهِ، وَالْمُنَافِقُ يَعْتِبُ عَثَرَاتِهِمْ" [آداب الصحبة للسلمي].
• كظم الغيظ
قال تعالى: {وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [آل عمران: ١٣٤].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ» [رواه البخاري].
عَنْ مُعَاذٍ بن جبل رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَنْتَصِرَ، دَعَاهُ اللَّهُ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي حُورِ الْعِينِ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ» [رواه أحمد في "المسند"].
وفي رواية عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ، مَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [المعجم الكبير].
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قال النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَمَنْ وَلِيَ شَيْئًا مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَضُرَّ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعَ فِيهِ أَحَدًا، فَلْيَقْبَلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ وَيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ» [رواه البخاري].
• خفض الصوت عند الاختلاف
ورفع الصوت وإن كان مذموما لغير حاجة فإنه عند الخلاف أشد ذمًّا لكونه باعثا على الغضب والتعصب والسب والتقاتل؛ قال تعالى: {وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} [لقمان: ١٩].
قال مُجَاهِدٌ بن جبر رحمه الله: "أَيْ: غَايَةُ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ أَنَّهُ يُشَبه بِالْحَمِيرِ فِي عُلُوِّهِ وَرَفْعِهِ، وَمَعَ هَذَا هُوَ بَغِيضٌ إِلَى اللَّهِ، وَهَذَا التَّشْبِيهُ فِي هَذَا بِالْحَمِيرِ يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ، وَذَمَّهُ غَايَةَ الذَّمِّ". [تفسير القرآن العظيم لابن كثير].
ومن صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ العَاصِ رضي الله عنهما: «وَلاَ سَخَّابٍ فِي الأَسْوَاقِ» [رواه البخاري].
"السخب": يقال فيه "الصخب": بالصاد المهملة بدل السين، وهو رفع الصوت بالخصام.
وقد أخذت الكراهة من نفي الصفة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نفيت عنه صفة الفظاظة والغلظة، وهذا القيد معتبر في النفي احترازًا من رفع صوته صلى الله عليه وسلم في القراءة والخطبة في المساجد وغيرها، فما بالنا بمن يرفع صوته، ويشوش على غيره حال الاختلاف والنزاع. [فتح الباري].
السلف الصالح ونماذج من أدبهم حال الاختلاف:
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا صَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ» فَسَلَّمَ وَقَالَ: إِنِّي كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الخَطَّابِ شَيْءٌ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَّ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ، فَقَالَ: «يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ» ثَلاَثًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدِمَ، فَأَتَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ، فَسَأَلَ: أَثَّمَ أَبُو بَكْرٍ؟ فَقَالُوا: لاَ، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، فَجَعَلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرٍ، فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ، مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ صَدَقَ، وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي» مَرَّتَيْنِ، فَمَا أُوذِيَ بَعْدَهَا. [رواه البخاري]
وقَالَ يُوْنُسُ الصَّدَفِيُّ: "مَا رَأَيْتُ أَعْقَلَ مِنَ الشَّافِعِيِّ، نَاظَرْتُهُ يَوْماً فِي مَسْأَلَةٍ، ثُمَّ افْتَرَقْنَا، وَلَقِيَنِي، فَأَخَذَ بِيَدِي، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا مُوْسَى، أَلاَ يَسْتَقيمُ أَنْ نَكُوْنَ إِخْوَانًا وَإِنْ لَمْ نَتَّفِقْ فِي مَسْأَلَةٍ" [سير أعلام النبلاء].
وقد اختلف ابن مسعود مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما في نحو مائة مسألة، ومع ذلك بقي الحب والتقدير بين الرجلين، يتجلى ذلك في ثناء كل واحد منهما على الآخر، فعمر يقول عن ابن مسعود: "كُنَيف ملئ علمًا" [مصنف عبد الرزاق]، ويقول ابن مسعود في عمر: "ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر"، ويقول: "لو وضع علم أحياء العرب في كفة، ووضع علم عمر في كفة لرجح بهم علم عمر" [البخاري وابن أبي شيبة].
فعن ابن بريدة الأسلمي قال: شتم رجل ابن عباس رضي الله عنهما، فقال ابن عباس: إنك لتشتمني وإن فيّ ثلاث خصال: إني لآتي على الآية في كتاب الله فلوددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم، وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح، ولعلي لا أقاضي إليه أبدًا، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب بلاد المسلمين فأفرح وما لي به سائمة" [مجمع الزوائد].
وجاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما، فقال: إني نذرت أن أنحر نفسي، فتجهمه ابن عمر وأفف منه، ثم أتى ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له: أهدِ مئة بدنة، ثم أتى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال له: أرأيت لو نذرت ألا تكلم أباك أو أخاك؟ إنما هذه خطوة من خطوات الشيطان استغفر الله وتب إليه، ثم رجع إلى ابن عباس فأخبره، فقال: أصاب عبد الرحمن، ورجع ابن عباس عن قوله [الدر المنثور للسيوطي].
خطوات عملية تساعد على الاختلاف المحمود:
- أحسن الظن بالمخالف: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرًا وأنت تجد لها في الخير محملًا" [قواعد الأحكام].
- حسن الاستماع إليه: فهذا عُتبة بْن رَبِيعَة حين كان يحاور النبي صلى الله عليه وسلم قال له: «قُلْ يَا أبا الوليد، أسمع»، ثم بعدما انتهى، قَالَ: «أَقَدْ فَرَغْتَ يَا أَبَا الْوَلِيدِ؟»، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَاسْمَعْ مِنِّي»؛ قَالَ: أَفْعَلُ". [رواه ابن إسحاق في "السير والمغازي"].
- تحلَّ بالصبر والحلم، ولا تتسرع في الرد: عن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الأَنَاةُ مِنَ اللَّهِ وَالعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ» [رواه الترمذي].
عن يُوسُف بْن الْحُسَيْنِ، قال: سَمِعْتُ ذَا النُّونِ، يَقُولُ: "أَرْبَعُ خِلَالٍ لَهَا ثَمَرَةٌ: الْعَجَلَةُ، وَالْعُجْبُ، وَاللَّجَاجَةُ، وَالشَّرَهُ، فَثَمَرَةُ الْعَجَلَةِ: النَّدَامَةُ، وَثَمَرَةُ الْعُجْبِ: الْبُغْضُ، وَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ: الْحَيْرَةُ، وَثَمَرَةُ الشَّرَهِ: الْفَاقَةُ". [رواه البيهقي في "ِشعب الإيمان"].
- تجنب أن تحمل الناس على قولك أو فعلك: قال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكَ هَدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [البقرة: ٢٧٢]، {لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ} [الغاشية: ٢٣].
- ابتسم في وجه من يخالفك: عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ» [رواه الترمذي، وابن حبان].
- التجمل بأخلاق الإسلام قدر الطاقة.
- إبداء النصيحة وليس النقد المباشر.
- احترم آراء الآخرين، ولا تقلل من وجهات نظرهم.
- عدم الاستعلاء بالحق أو بالإيمان .
- إن أمكنك في النهاية أن تقدم له هدية ولو بسيطة فافعل: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «تَهَادَوْا فَإِنَّ الهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ، وَلَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ شِقَّ فِرْسِنِ شَاةٍ» [رواه الترمذي، وأحمد].
- الاتفاق على ما يحقق المصلحة العامة للبلاد والعباد، وإبقاء الود والاحترام المتبادل.
- إذا ظهر الحق مع مخالفك فاقبله، وإذا قبله منك فاشكره، ولا تمن عليه.
- عَنْ أَبِي الْعَوَّامِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: "كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: وَلَا يَمْنَعْكَ مِنْ قَضَاءٍ قَضَيْتَهُ الْيَوْمَ فَرَاجَعْتَ فِيهِ رَأْيِكَ، وَهُدِيتَ فِيهِ لِرُشْدِكَ، أَنْ تُرَاجِعَ الْحَقَّ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ لَا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ، وَمُرَاجَعَةُ الْحَقِّ خَيْرٌ مِنَ التَّمَادِي فِي الْبَاطِلِ" [رواه البيهقي في "السنن الكبرى"].
- عدم التعدي على المخالف، أو الحكم عليه بفسق أو بدعة أو بكفر: فعن يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله، قال: "ما برح أولو الفتوى يختلفون، فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يرى المحرم أن المحل هلك لتحليله، ولا يرى المحل أن المحرم هلك لتحريمه" [جامع بيان العلم وفضله].
- أرجىء النقاش والخلاف إلى وقت آخر، إذا كان الاستمرار فيه يؤدي إلى النزاع والعراك والنفور.
الخطبة الثانية
التعدي على الجار
تُعتبر العلاقة مع الجار من أسمى الروابط الاجتماعية التي حث عليها الدين والقيم الإنسانية، لما لها من أثر كبير في تعزيز التآلف والتماسك المجتمعي.
إلا أن ظاهرة التعدي على الجار -سواء كان ذلك بالتعدي على حقه في الخصوصية، أو إلحاق الضرر المادي أو النفسي به- أصبحت ظاهرة متزايدة تهدد استقرار المجتمع وتخل بروابط المحبة والاحترام.
وتهدف مبادرة "صحح مفاهيمك" إلى تسليط الضوء على أهمية احترام الجار وحقوقه، وتصحيح السلوكيات الخاطئة التي قد تؤدي إلى التعدي عليه، من خلال خطاب دعوي وتوعوي يركز على القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية.
الإحسان إلى الجيران واجب شرعي:
أوجب الإسلام على المسلم الإحسان إلى الجار، والتودد معه، والعطف عليه، ورعايته في كل شئونه، وجاءت الوصية به في كثير من آي الذكر الحكيم، قال تعالى ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ [النساء: ٣٦].
وعن مُجَاهِدٍ رحمه الله، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما ذُبِحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِجَارِنَا اليَهُودِيِّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ». [رواه الترمذي وحسنه].
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» [رواه مسلم].
الجيران ثلاثة:
اهتم الفقهاء بمبحث الجار اهتمامًا كبيرًا، فقسموه إلى أنواع، وبينوا حق كل نوع منها، ومن خلال استقراء النصوص تبين أن الجيران ثلاثة:
- جارٌ له ثلاثة حقوق: وهو الجار المسلم القريب ذو الرحم، له حق الجوار، وحق الإسلام، وحق القرابة.
- جارٌ له حقان: وهو الجار المسلم، له حق الجوار، وحق الإسلام.
- جارٌ له حق واحد: وهو الجار غير المسلم، له حق الجوار، وأمرنا الإسلام بحسن معاملته، وعدم التعرض له بأي نوع من الإيذاء قولًا كان أو فعلًا، قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الممتحنة: ٨].
وضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن الجوار مع غير المسلمين، فلم يؤثر عنه أن تعدى عليهم أو تعرض لهم بأي لون من ألوان الأذى أو المضايقة، بل كان يتفقد حالهم إذا غابوا، أو يقدم لهم العون إن احتاجوا؛ فعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّ غُلَامًا مِنَ الْيَهُودِ كَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرِضَ، فَأَتَاهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ: «أَسْلِمْ»، فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ، وَهُوَ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ لَهُ: أَطِعْ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ، فَخَرَجَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ» [رواه البخاري].
وقد وضع الإمام الحسن البصري رضي الله عنه قاعدة عريضة في حد الجار، حينما سُئِلَ عَنِ الْجَارِ، فَقَالَ: "أَرْبَعِينَ دَارًا أَمَامَهُ، وَأَرْبَعِينَ خَلْفَهُ، وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَسَارِهِ" [رواه البخاري في "الأدب المفرد"].
وإذا كان تحديد الجوار أربعين دارًا، وكلها داخل في الوصية بالجار، فهذه الأربعون تتفرع، فأقصى بيت من الأربعين يراعي حقوق أربعين بيتًا أخرى وهكذا، فتكون النتيجة: أن تتموج حقوق الجوار وتنتشر كتموج موجات الأثير حتى تعم العالم كله، ولا يبقى شبر على وجه الأرض إلا ودخل في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو راعينا حرمة الجوار بين المدن والأقطار، لحصل خير كثير، فكل دولة تراعي حقوق جارتها؛ فالجوار بهذا المفهوم يشمل الجميع، وبهذا يعم السلام، وتُحفظ الإنسانية من الاعتداء على أرضها وعرضها ومالها، وهذا مقصد رباني حثت عليه كل الشرائع السماوية.
أذى الجيران مُحبط للعبادة:
فعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا، وَصِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي النَّارِ»، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: فَإِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا، وَصَدَقَتِهَا، وَصَلَاتِهَا، وَإِنَّهَا تَصَدَّقُ بِالْأَثْوَارِ مِنَ الْأَقِطِ، وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ: «هِيَ فِي الْجَنَّةِ». [رواه أحمد].
ومن أراد أن يعرف أنه محسن، فلينظر إلى حاله مع جيرانه، هل يحسن إليهم أم لا؟ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُ بِهِ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: «كُنَّ مُحْسِنًا» قَالَ: كَيْفَ أَعْلَمُ أَنِّي مُحْسِنٌ؟ قَالَ: «سَلْ جِيرَانَكَ، فَإِنْ قَالُوا: إِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، وَإِنَّ قَالُوا: إِنَّكَ مُسِيءٌ فَأَنْتَ مُسِيءٌ» [رواه البيهقي في "شعب الإيمان"].
التعدي على الجيران.. حرمته وعقابه:
التعدي على الجوار من علامات الساعة؛ فعن عَبْد اللَّهِ بْن عَمْرِو رضي الله عنهما، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ، وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ، وَسُوءُ الْجِوَارِ». [رواه أحمد].
وقد حرم الإسلام التعدي على الجار بأي شكل من الأشكال، سواء بالقول أو الفعل، بل يرتقي الإحسان إليه إلى درجة عبادة الله، ويُعَد إيذاؤه جريمة أخلاقية واجتماعية؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ» [متفق عليه].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» [رواه مسلم].
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ» قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «جَارٌ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا بَوَائِقُهُ؟ قَالَ: «شَرُّهُ» [رواه أحمد].
قال أ.د/ موسى شاهين لاشين: (إن الأمن على النفس والمال والعرض من نعم الله الكبرى، وأقرب الناس تهديداً لهذا الأمن هو الجار؛ لأن الحذر منه أصعب من الحذر من غيره، والضرر منه أشد خطرًا من الضرر من غيره، إنه يعرف كثيرًا من الخفايا، ويكشف كثيرًا من الأستار، ويطلع على كثير من العيوب، إنه أعلم بمواطن الضعف، وأقدر على توصيل الأذى.
والإسلام يحرص على استتباب الأمن، ونشر الطمأنينة والاستقرار بين أبناء المجتمع الواحد، لهذا جعل مسالمة الجار من الإيمان، وجعل حبس النفس عن أذى الجار من الإيمان، بل جعل خوف الجار من الجار دليلًا على ضعف إيمان الجار الذي بعث الخوف، وإن لم يصل ضرره لجاره بالفعل ...، نعم هذا التشريع الحكيم لو أمن كل جار جاره، وكف كل جار عن ضرر جاره، وحمى كل جار محارم جاره، لكانت المدينة الفاضلة، ولكان المجتمع الموادع الأمين، ولعاش الناس سعداء آمنين) [فتح المنعم شرح صحيح مسلم].
إشاعة عيوب الجار من الفواقر
فعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: "ثَلَاثٌ مِنَ الْفَوَاقِرِ: ...، وَجَارٌ إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا، وَزَوْجَةٌ إِنْ حَضَرْتَ آذَتْكَ وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا خَانَتْكَ فِي مَالِكَ وَنَفْسِهَا". [رواه وكيع بن الجراح في "الزهد"].
الصبر على أذى الجار:
ديننا الحنيف كما ينهى عن التعدي على الجار، كذلك يُرغب في الصبر على أذاه، وتحمل ما يصدر منه، فمن تصبَّر عليه نال محبة الله؛ فعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه، قال: قال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ...، وَرَجُلٌ لَهُ جَارٌ يُؤْذِيهِ، فَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُ وَيَحْتَسِبُهُ حَتَّى يَكْفِيَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ بِمَوْتٍ أَوْ حَيَاةٍ». [رواه أحمد].
والتعدي على الجار يجلب اللعنة لصاحبه؛ فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو جَارَهُ، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاصْبِرْ» فَأَتَاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاطْرَحْ مَتَاعَكَ فِي الطَّرِيقِ» فَطَرَحَ مَتَاعَهُ فِي الطَّرِيقِ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ: فَعَلَ اللَّهُ بِهِ، وَفَعَلَ، وَفَعَلَ، فَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ: ارْجِعْ لَا تَرَى مِنِّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ. [رواه أبو داود].
حرمات الجار:
ربَّى الإسلام المسلم على حفظ حرمات الجار، وعدم التطلع إلى عورته؛ فعن الْمِقْدَاد رضي الله عنه، قال: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ عَنِ الزِّنَا؟ قَالُوا: حَرَامٌ، حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: «لِأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارِهِ»، وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ؟ قَالُوا: حَرَامٌ، حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: «لِأَنْ يَسْرِقَ مِنْ عَشَرَةِ أَهْلِ أَبْيَاتٍ، أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ» [رواه أحمد].
ولله در حاتم الطائي حيث قال:
نَارِي وَنَارُ الجَارِ وَاحِدَةٌ ... وَإلَيهِ قَبلي تَنزِلُ القِدرُ
مَا ضَرَّ جَارًا إِلَيَّ أُجَاوِرُهُ ... أَلَا يَكُوْنَ لِبَيْتِهِ سِتْرُ
أَعْمَى إِذَا مَا جَارَتي ظَهَرَتْ ... حَتَّى يُغَيِّبَ جَارَتِي الخِدْرُ
ويَصَمُّ عمَّا كانَ بينَهما ... سَمْعي وما بي غيْرَهُ وَقْر
تنشئة الأولاد على احترام الجيران:
يجب تربية الأولاد على تعظيم حق الجار، وكف الأذى عنه، وإخبارهم بما في إكرامه من عظيم الأجر، وما في أذيته من الوعيد الشديد؛ إذ الأذية قد تصدر من زوج الرجل أو ولده، فلا يتساهل معهم، بل يظهر غضبه عليهم؛ ليعلموا أن هذا الأمر شنيع فلا يتهاونون، ولا يستخفون به؛ ولذا كان العرب في الجاهلية يتفاخرون بحسن الجوار، وعلى قدر الجار يكون ثمن الدار، وقد باع أحدهم منزله فلمَّا لاموه في ذلك قال:
يلومونني أَنْ بِعتُ بالرخص منزلي *** ولم يعرفوا جاراً هناك ينغــِّصُ
فقلتُ لهم: كفوا الملام فإنمــا *** بجيرانها تغلوا الديار وترخصُ
قال ابن العربي المالكي: (على المرء أن يوقِظَ جارَهُ من الغَفَلاتِ، وينقله إلى الطاعات، ويأمره بإقامة الصلوات، وهذا من حقوق الجوار، وقيل: إنَّ الجار الصالح يشفعُ يومَ القيامةِ في جيرانه ومعَارِفِهِ وقَرَابَتِه.
وأنشد بعضهم:
يا حَافِظَ الجَارِ يَرْجُو أنّ يَنَالَ بِهِ ... عفْوَ الإلَهِ وعَفْو الله مَذْكُورُ
الجَارُ يشْفَعُ للْجِيرَانِ كلّهِم ... يَوْمَ الحِسَابِ وذنب الجَارِ مَغْفُورُ).
[المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك، ٧/ ٣٩٥].
الجوار والأحكام الفقهية:
ذكر الفقهاء أحكامًا فقهية كثيرة متعلقة بجيران الدور، وجيران المزارع ... إلخ، وذكروا ما يُمنع الإنسان من فعله في ملكه أو في مشترك بينه وبين جاره كالطريق ونحوه، وضابط ذلك: "أنه ليس للإنسان أن يتصرف في ملكه بما يتعدى على جاره"؛ عملاً بحديث أبي سعيد الْخُدْرِي رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَرَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ» [رواه الدارقطني في "سننه"، والبيهقي في "السنن الكبرى"].
وإذا احتاج الجار إلى منفعة في دار جاره أو حائطه، فلا يمنعه منها إذا كان ذلك لا يضره، ومنعه منها يوقع الأذى عليه؛ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ»، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ، وَاللهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ [متفق عليه].
وكي يمنع وقوع التعدي على الجار، بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أن "الجار أحق بالشُّفعة"، وأنه يحتاج إلى إذنه قبل بيع ما يلاصقه من أرض أو زرع حفظًا لحق الجِوار؛ فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَا، فَلْيَعْرِضْهَا عَلَى جَارِهِ» [رواه ابن ماجه].
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي اللهُ عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا» [رواه أبو داود، وأحمد].
الجوار علاقة مقدسة تعكس مدى حضارة المجتمع وقيمه.
خطوات إجرائية لتعزيز الوصية بالجار:
- التزام حسن التعامل، كالسلام والتحية والابتسامة.
- مراعاة الهدوء والاحترام في المواقف المختلفة.
- المشاركة في المناسبات الاجتماعية، وتقديم الدعم عند الحاجة.
- الحرص على زيارات منتظمة للجار، لا تكون مشروطة بالمصالح.
- تشجيع الأولاد على التعارف على الجيران وحقوقهم والتواصل المستمر.
- تجنب الغضب أو الشحناء مع الجيران.
- حفظ الأمانة والسرّ عند التعامل معهم.
اقرأ أيضا:
د. نظير عياد: وحدات دار الإفتاء تعزز قيم التعايش والتسامح وتنشر فقه الوسطية في العالم
علماء دار الإفتاء: الرشوة تقوض أسس العدالة والمساواة
كيفية التعامل مع جارالسوء والتدخل في خصوصيات البيوت بمجالس توعوية للإفتاء
هل يجوز تيمم المرأة بمكياجها بديلا عن الوضوء؟
حكم خروج الزوجة من المنزل بدون اذن زوجها
دكتور شوقي علام يوضح حكم سنة الجمعة القبلية
حكم صلاة الظهر بعد أداء فرض الجمعة
الرابط المختصر
آخبار تهمك
مطار مرسى علم الدولي يستقبل 19 رحلة أوروبية اليوم
26 فبراير 2026 05:00 ص
تعرف على أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الخميس 26 فبراير
26 فبراير 2026 04:00 ص
6965 جنيهًا لعيار21.. أسعار الذهب اليوم الخميس 26 فبراير
26 فبراير 2026 02:00 ص
تعرف على أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الأربعاء 25 فبراير
25 فبراير 2026 07:00 ص
6970 جنيهًا لعيار21.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأربعاء 25 فبراير
25 فبراير 2026 03:00 ص
سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy S26 Ultra الجديد
24 فبراير 2026 07:22 م
الأكثر قراءة
-
كريستيانو رونالدو يستحوذ على 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني
-
دوري السلة الإفريقي يعلن الأندية المشاركة وجدول مرحلة المجموعات 2026
-
موعد مباراة مصر ومالي والقناة الناقلة في كأس العالم للسلة
-
عودة محمد شريف لتشكيلة الأهلي أمام زد بعد غياب طويل
-
حمزة عبد الكريم يقترب من المشاركة مع برشلونة بعد استكمال تصريح العمل
-
الأهلي يطعن على حكم «فيفا» لصالح خوسيه ريبيرو
-
بعد أهوال الحرب والفقد، طفلة فلسطينية: وجدت في مصر الآمان
-
الهلال الأحمر يدفع بقافلة «زاد العزة» 147 بحمولة 6,240 طنًا من المساعدات
-
موعد امتحانات الترم الثاني 2026 لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل
-
هل يتم عقد امتحانات شهر مارس 2026 في نهار رمضان؟، وزارة التعليم تحسم الجدل
أكثر الكلمات انتشاراً